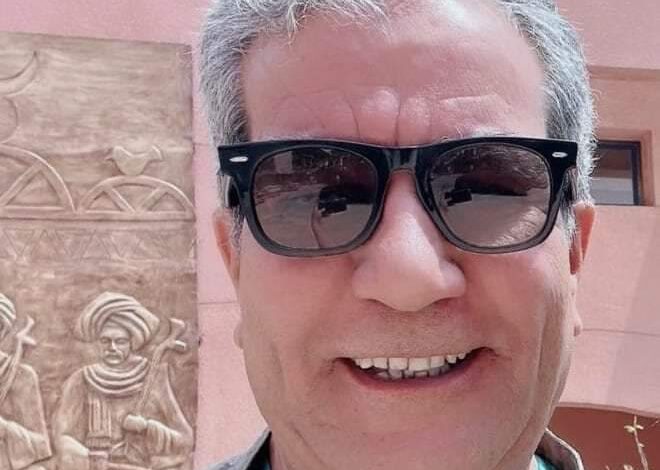
المسرح نيوز ـ القاهرة| مقالات ودراسات
ـ
الناقد: محمد الروبي
مصر
بمناسبة ( رد الجميل ) في ( التجريبي ) أعيد نشر ورقتي عنه التي ألقيتها في الأردن – بلده الثاني – منذ عام على هامش مهرجان ( الرحالة ).
“مسرح السيارة”، “مسرح الحقيبة”، “مسرح الصيادين”، “مسرح المقهى” و.. و……
قد لا يعرف الكثيرون، وخاصة من شباب المسرح العربي، أن هذه الصفات السابقة التي يسمعون عنها الآن منبهرين باعتبارها فتحا جديدا في عوالم المسرح، أن هناك رجلا مصريا ابتدعها عربيا منذ أواخر ستينيات القرن الماضي. رجل أهم صفاته الإنسانية أنه محب للناس وللحياة، رجل “زرباوي” بامتياز، عاش بالحب ومات محبا وترك لمحبيه دوحة كبيرة لايزالون يستظلون بظلها ويجنون من ثمارها ما يُعينهم على المسرح والحياة.
في بدايات علاقتي العلمية بفن المسرح، حين قررت نفض أعباء الكهرباء والميكانيكا التي لا أحب، واللوذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية لدراسة وممارسة ما أعشق، لم يكن عبدالرحمن عرنوس أحد مدرسيه؛ إذ إنه كان في الأردن، يغرس شتلة جديدة لدوحة مسرحية جديدة.
في المعهد صادفني اسمه كثيرا، لكن ما لفتني وجعلني متشوقا للقائه أنني لم أجد إجماعا عليه، فالبعض حين تذكر اسمه أمامه يكتفي بلوي شفاهه امتعاضا ولا ينبس بكلمة، فتفهم أنت أن من تسأل عنه (شيء).. نعم، مجرد شيء مثير للاستياء، ولا يستحق حتى مجرد ذكره أو الاستماع لاسمه. في المقابل وجدت آخرين يتحدثون عنه بإجلال لا يليق إلا بأولياء الله الصالحين. بل ويسترسلون في الحديث عن ذكرياتهم معه بوله المريدين الذين يحدثونك عن معجزات شيخهم.
تعارض الآراء حول الرجل، إلى حد التناقض، جعلني أكثر شوقا لمعرفته. وهي المعرفة التي ستأتي بعد سنوات من تخرجي في المعهد. مصادفة كنت أظنها عابرة، فإذا بها بداية لطريق طويل من الصداقة والتلمذة والأبوة.
كنت في بدايات ممارستي لمهنتي كناقد، حين استُدعيت من قِبل إدارة مسرح الثقافة الجماهيرية للمشاركة في لجنة تحكيم عروض بإحدى محافظات مصر الساكنة على الأطراف. في السيارة جاءت جلستي إلى جواره نجاور معا السائق. وفورا سألني، وقبل أن يهديني سلاما بلهجة بورسعيدية مميزة (أنت مين يا وله)!
(وله)!!.. تغاضيت عما اعتبرته قلة ذوق، وأجبته بامتعاض: (محمد الروبي). وقررت بيني وبين نفسي أن أقيم ستارا من صمت يفصل بيننا طوال الرحلة والأيام التي سأقضيها مضطرا بصحبته. فيبدو أن الممتعضين بالمعهد كان لديهم كل الحق.
لكن الأمر لم يفلح، فإذا به يباغتني (أنت بقى الروبي اللي بيقولوا عليه؟) نظرت إليه باندهاش مستاء ولسان حالي ينطق بما لم أنطق به: (يقولون؟ ماذا يقولون؟ ومن أولئك الذين يقولون؟) تجاهل هو نظرتي واستطرد: (اسمع يا وله عاوز أقولك حاجة.. شكلك شاطر زي ما سمعت عنك.. بس خلي بالك.. الوسط ده مليان ناس جواميس ولاد (…..) سيبك منهم وما تعملش إلا اللي في دماغك.. عارف يا وله أنا قبلت السفرة دي ليه؟ عشان مصر واحشاني.. مصر اللي بجد مش بتاعة المحفلطين الملزقين اللي داهنين جسمهم زيت.. خذ) ومد لي يده بسيجارة رخيصة وأخرى للسائق مشفعا إياها بقوله: (خد يا اسطى.. انفخ.. بس ياكشي تكون بتعرف تسوق وما تلبسناش في شجرة… شكلك عبده كاوتش). ابتسمت أنا، ثم ضحكت.. ورويدا رويدا بدأ الستار الذي أسدلته ينفرج ببطء حتى صرنا، هو وأنا، في عالم خاص منفصلين تماما عن أحاديث الزملاء خلفنا، لا نعود إلى عالمهم إلا حين يلتفت هو إليهم قاطعا حديثه معي بتعليق يتسبب في غرق الجميع في ضحك يصل إلى حد الصراخ.
عبر المسافة التي قطعتها السيارة في ساعتين ونصف، لم نتوقف خلالها إلا مرة واحدة لنشرب شايا، صار عبدالرحمن عرنوس الصديق الذي أعرفه منذ سنوات. في الرحلة اكتشفت أنه يرتدي قناعا سميكا من السخرية يخفي تحته علما غزيرا لا بالمسرح فقط ولكن بالبشر والحياة. حدثني عرنوس عن بداياته وعن أساتذته وتلامذته. حدثني عن أمه التي سيزور قبرها فور عودته. حدثني عن بورسعيد وشباب البحر؛ الفرقة التي كونها من طلاب الجامعة تغني أغاني المقاومة التي ألفها خصيصا لها. حدثني عن جمال عبدالناصر الذي أحب. وفاجأني بأنه هو صاحب نشيد الوداع الذي كنا نغنيه وصار فيما بعد أيقونة أوركسترالية عالمية.
عرفت منه أن الأغنية كانت مجرد هتاف قاله عفو الخاطر أثناء سيره ضمن ملايين في مظاهرة وداع جمال عبدالناصر.. ثم امتدت إليه أياد تخطفه لتلقي به في مبنى الإذاعة ليستكمل أبيات هتافه بلحنه العفوي، فتتحول هناك أغنية تذاع فورا عبر الأثير ليسمعها الملايين وتصير أيقونة وداع رجل عظيم:
“الوداع يا جمال يا حبيب الملايين.. الوداع”
“ثورتك ثورة كفاح عشتها طول السنين.. الوداع”
…………..
غضب ودرس فمنهج حياة
وصلنا المدينة، وفي المساء بدأت أولى مشاهداتنا للعروض، وكان المتبع أن نجلس مع الممثلين والمخرج والفنيين عقب كل عرض نناقشهم فيما قدموه، ونُسمعهم رؤيتنا لما شاهدناه. وهنا اكتشف عرنوس أنني أقسو على الشباب بأكثر مما يجب، فكتم غضبه حتى عدنا إلى الفندق نجلس في باحته المطلة على بحيرة ساكنة. في الجلسة، فاجئني عرنوس بغضبه عليّ من قسوتي على الشباب، مختصرا رأيه في جملة صارت فيما بعد نبراسا ومنهجا أتبعه حتى الآن. قال لي وهو يقف مادا كرشه إلى الأمام واضعا يديه في وسطه: (اسمع يا يالا.. علمّوهم قبل أن تحكمّوهم) وتركني العجوز الغاضب وحدي أتأمل جملته، وأراجع موقفي وأبحث عن سبيل كيف يمكن أن نعلم هؤلاء الهواة؟ وهو السؤال الذي دفعني إلى أن أقترح على مسئولي إدارة المسرح إقامة دورات تدريبة في كافة عناصر العرض المسرحي لكل مجموعات فرق المحافظات المختلفة. وهو الاقتراح الذي صار يتطور ويتطور حتى وصل الآن إلى مشروع يُعرف في مصر الآن باسم (ابدأ حلمك).
طوال خمسة أيام قضيناها هناك في المحافظة البعيدة كنا، هو وأنا، كظلين لشخص واحد. اكتشفته أكثر وتعلمت منه الكثير حتى وهو يطلق على الآخرين أعيرته القولية وألفاظه المدهشة، ومن بينها اسم (عبده)الذي كان يلحقه بوصف خاص جدا، يكفي أن تسمعه لتعرف عمن يتحدث، فذلك (عبده حنجرة)، وذلك (عبده المنفوخ)، وهذا (عبده شوربة) و.. و… وغيرها من الصفات التي ستدهشك دقتها في اختصار من نتحدث عنه.
———————
البيت المفتوح
مع انتهاء الأيام الخمس، صار عرنوس صديقا، أستاذا، أبا، بل وابنا. حرصنا على اللقاءات والمناوشات والمداعبات والنميمة المحببة. وهو لا يكف، مهما كانت خبرتك به، عن إدهاشك. لكن ستبقى زيارتي الأولى لبيته هي بمثابة الدهشة الأكبر. فالبيت القاطن بدور أرضي ببناية متهالكة في حي شعبي عريق لم يكن بيتا بالمعنى المعروف. فهو مكان له باب لا يغلق بمفتاح أو مزلاج سواء كان صاحبه بداخله أم غائبا عنه. أنت تذهب لبيت عرنوس واثقا أنك ستدخل. وماذا؟ أو من سيمنعك من الدخول؟ فالباب مفتوح وجيران الحي (بائعة الخضرة، والميكانيكي، والنجار، وصبي المقهى، و..و..) يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وآباءهم. يحيطونه بحماية مدهشة. سيستقبلونك بترحاب رغم أنهم يرونك للمرة الأولى، فأنت صديق عرنوس إذن فأنت مثله لك عليهم حق الحب والاحتواء.
في الداخل، داخل البيت، ستكتشف أنه مجرد مكان للمأوى، مقاعده قليلة أغلبها متهالك؛ بل قد لا تجد مكانا للجلوس، فالبيت عامر دوما بالزوار، يعرفهم عرنوس من قبل أو لا يعرفهم: نساء ورجال، شباب على عتبات الفن أو مخضرمون من جيله ومن أجيال أسبق. والجميع يخدم نفسه بنفسه؛ بل قد يطلب هو من زائر أن يفز يعمل له وللآخرين شايا (ما تبقاش عبده التنح).
بيت عرنوس عالم خاص من لم يزره ولو لمرة فقد فاته الكثير.
————————-
قال لي
كان كل لقاء لي مع عرنوس هو بمثابة درس في الفن والحياة؛ بل وكانت الدروس الأهم في ورشة تدريب الممثل التي كان يقدمها بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وفيها سمعت نصيحة يلقيها على تلامذته لم أفهمها في حينها، ولكنها أصبحت بعد ذلك سراجا أنير به الطريق لتلامذة لي سواء في المعهد (العالي للفنون الشعبية) أو في الورش الخاصة التي أُدعى إليها أحيانا للحديث مع أعضائها. كانت نصيحة عرنوس هي (اكسر خجلك). وعرفت بعدها –مع مداومة الحضور– أنه يعني أن يتعرف الممثل/ الممثلة على جسده ولا يخجل منه. فالجسد هو الأداة الأولى والأهم في أدوات الممثل، وهو ما يجعلنا نفهم سخريته من بعض الممثلين حين يصفهم بـ(عبده حنجرة)، وهو أسوأ أنواع الممثلين عند عرنوس، ذلك الذي يقع في غرام صوته ويظن أنه كافٍ للتعبير.
الجسد عند عرنوس هو الممثل، إذا لم يكن طيعا خفيفا متلونا محكوما بقدرة الممثل على تطويعه، فهو جسد عبء على صاحبه؛ بل والأفضل أن يكتفي بالتمثيل الإذاعي.
كذلك علمني عرنوس أن النص المكتوب هو أداة يمكن الاستغناء عنها. لذلك كان يهتم كثيرا بتدريبات الارتجال التي تشعل خيال الممثل وتمنحه القدرة على أن يختصر الكلمات في حركة أو إيماءة أو صمت.
والأهم عند عرنوس هو وعي الممثل، ليس فقط بالشخصية التي يقدمها ولا فقط بالعرض ككل، لكن بالعالم المحيط به. فممثل لا يتذوق الشعر والموسيقى والفن التشكيلي هو ممثل ناقص. وربما كانت تجربة مقهى (أسترا) التي كانت مجمعا للشعر والغناء والربابة ومباريات النكات اللاذعة على الهواء، خير مثال على أن كل ذلك هو معين للممثل كما يجب أن يكون.
علمني عرنوس ألا أهتم بكيف سأكون في عيون الآخرين، فالأهم كيف أكون في عين نفسي، أو كما كان يقول دوما (كن أنت.. لا تقلد ولا تتخذ من نفسك مرآة تنعكس عليها صورة الأستاذ).
وهكذا، وعبر السنوات القليلة التي صاحبت فيها عرنوس، حاولت وما زلت ألا أكون عرنوسيا رغم الاحترام والتقدير اللذين أكنهما له،وكلما ضغطت عليّ الحياة تذكرت جملته التي باغتني بها في أول لقاء (كن أنت.. ولا تلتفت لولاد ال…. اللي عاوزين الناس نسخة طبق الأصل من صورة باهتة).
رحم الله عبدالرحمن عرنوس، العجوز الذي كرهته ثم صار صديقا وأبا وأستاذا.. بل وابنا.
……………………………






