د. أحمد محمود سعيد يكتب رؤية نقدية لمسرحية الناس في طيبة لعبد العزيز حمودة
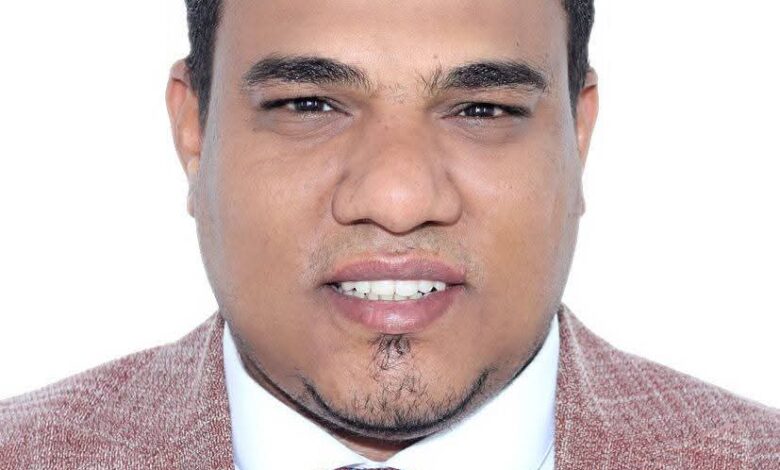
المسرح نيوز ـ القاهرة: مقالات ودراسات
ـ
د. أحمد محمود سعيد
مسرحية ” الناس في طيبة (1979م) (¥) عبد العزيز حمودة (¥) “:
تعامل عبد العزيز حمودة مع المنتج التراثي في هذه المسرحية بوعي تام ينم عن قدرته الثقافية في الوقوف عند مناطق تراثية لها أثر فعال في الذاكرة العربية، فقد استلهم الأسطورة وأعاد صياغتها من جديد، ليظهر تناقضات واقعه ومفارقاته السياسية من خلال محافظته على أركان الأسطورة بمسمياتها المعروفة من جانب، وبلورة المضمون التراثي من جانب آخر، حتى يتسنى له تقديم مضمون سياسي مرتبط باللحظة التاريخية المعاصرة، وما بها من ثقافات متضاربة في الحكم والسلطة،
وتجلى ذلك بصورة واضحة في شخصية (ست)، التي حملت رؤية الكاتب السياسية، وفي الوقت نفسه جاءت رمزًا –من وجهة نظر الباحث– إلى الزعيم الراحل (جمال عبدالناصر)، الذي تبنى الفكر الاشتراكي اجتماعيًّا وسياسيًّا، والكاتب من أنصار الحزب الناصري، فهو اشتراكي حتى النخاع، ومن ثمَّ/ فإن المسرح عند عبد العزيز حمودة الذي اعتمد على مصادر التراث هو مسرح ذو هوية عربية، يعزز من قيم الوحدة والتعاون والتكاتف … من أجل بناء مجتمع نهضوي يساير باقي المجتمعات المتقدمة.
أنساقية العنوان:
عند احتكاك المتلقي المباشر بعنوان المسرحية (الناس في طيبة)، يلحظ أنه تضمن كتلة ثقافية، يحاول الكاتب من خلال العنوان تركيز الضوء عليها، وهي (شعب طيبة)، وقد اختار طيبة خاصة، لأنه حيز مكاني مرتبط ارتباطًا وثيقًا ببنية الأسطورة (إيزيس وأوزوريس)، أو ربما لكون هذا الشعب معادلًا موضوعيًّا للشعب الذي يقصده عبدالعزيز حمودة واقعًا، والناظر في العنوان يجده مبهمًا وغير واضح (الناس في طيبة؟ مالهم!) كأن الكاتب يريد إعمال ذهن المتلقي، ليقدم عدة تأويلات ثقافية قبل الولوج إلى عالم المسرحية، أو أنه يصنع حالة من التكثيف الدلالي لهذا النسق، ليصبح نسقًا أكثر اتساعًا، تتفاعل معه مجموعة الأنساق الأخرى.
النسق المثالي/ أوزوريس:
يظهر أوزوريس بأبعاده التراجيدية معبرًا عن النسق المثالي، أي النسق الذي يحمل ملامح المثالية في التعامل مع الشعب والحاشية، فقد غاب عن طيبة عشر سنوات، وتركها لإيزيس مليئة بالخيرات من سدود وترع وزراعة ..، وعند عودته ونجاته من عملية اغتيال خططت لها إيزيس والكاهن الأعظم، وجد طيبة غير الذي تركها، يعمها الفقر والجوع والجدب من كل الأطراف.
أوزوريس: حدث أنني منذ اللحظة التي وطنت فيها قدماي أرض طيبة رأيت شعبًا غير الشعب، وأناسًا غير الناس… شعبًا خائفًا تنطق عيناه بالذعر… رأيت شبابًا شاخوا في سن الشباب، رأيت وجوها صفراء كالحة، رأيت فقرًا مقيمًا ..، رأيت أيدي تصفق وعيونًا تلفن، رأيت ورأيت ورأيت….
ايزيس: (بنغمة أقل كبرياء) لقد شهدت طيبة في الفترة الأخيرة سنوات عجاف يا مولاي.. انخفض منسوب المياه و …([1])
يكشف الحوار بين أوزوريس وايزيس عن مفارقة واضحة بين حالة الشعب في حكم أوزوريس وحالته العكسية في حكم ايزيس، فقد ذاق القهر والقمع والخوف والفقر، وهذا ما كشفه أوزوريس عند قدومه، لذلك تحاول ايزيس تبرير هذا الموقف، لكن أوزوريس يعلم الحقيقة، فقد استولت ايزيس والكاهن الأعظم على خزائن الدولة، وكأن الكاتب بهذا التصور يكشف عن منظومة فساد تخللت بنية المجتمع آنذاك. إن ظهور شخصية أوزوريس المثالية، التي تحاول النهوض بطيبة، على مدار عدة أنساق ثقافية متنامية في الخطاب الدرامي، تحيل إلى دلالة ثقافية بعينها، وهي السعي إلى التغيير والمشاركة الفعالة بين الشعب والحاكم، فالحكم لا يقوم على طرف واحد بل بين طرفين يجمعهما هدف مشترك واحد، وهذا الموقف الثقافي فردي تبناه أوزوريس وحاول تطبيقه مع شعب طيبة، لكنه باء بالفشل، وهذا ما أدى إلى ظهور صورة الشعب في نمط الاتكالية، كأن المضمر في العنوان (الناس في طيبة اتكالين)،
ومن ثمَّ/ ظهر صوت ثقافي آخر معاكس لصوت أوزوريس في الحكم، وهو صوت (ست)، ولعل إقصاء -الكاتب- أوزوريس عن الحكم لمدة طويلة، وتولية ايزيس من بعده، يعكس موقفين ثقافيين متضادين، يعبران عن صورة الواقع الحقيقي/ ايزيس، والواقع المتخيل/ أوزوريس؛ مما يمنح الكاتب فرصة لفضح الأنظمة السياسية المتسلطة، ولعل هذا يرجع إلى معايشة الكاتب واقعًا سياسيًّا مؤلمًا، دفعته إلى التواري خلف المخيلة الأسطورية.
(فجأة يفلت صوت الرجل فيتوقف الموكب من جديد)
الرجل: مولاي … يتكفل به الرجلان
أوزوريس: ماذا تريد يا رجل؟
رجل: (من الممسكين به) إنه يريد أن يقول يا مولاي
أوزوريس: دعه يتحدث بنفسه
الرجل: أود أن اقول يا مولاي.. يفلت الآن من الرجلين ويقترب من محفة الملك.. ثم ينحني قليلًا ويصمت..
أوزوريس: ماذا كنت تريد..؟ تكلم …
الرجل: كنت أريد أن أقول.. أريد أن أقول.. (اللحظات صمت حرجة، يرفع الجميع رؤوسهم إلى الرجل في توقع .. أريد أن أقول أن الناس في طيبة.. الناس في طيبه سعداء يا مولاي.. ([2])
يلحظ في الحوار السابق أن الكاتب يريد أن يكشف عن سطوة التهميش والاقصاء، التي بدت في حديث الرجل مع أوزوريس/ الحاكم؛ ليس ذلك فحسب؛ بل جعل سطوة التهميش نابعة من الداخل أي من أبناء الطبقة الواحدة، لا من الطبقة الحاكمة فقط؛ ليعطي صورة واضحة لثقافة الحكم في عهد ايزيس، فقد أصبح القهر لغة الشعب بأكمله،
إن النسق المشابه الذي استوحاه الكاتب من البيئة المهمشة (الرجل)، يوحي إلى قهر الطبقة الدونية، وممارسة السلطة وسائل القمع كافة، من أجل المحافظة على السلطة من الضياع، وهذه ثقافة خاصة بالحكم يتبعها بعض حكام العرب، إذ إن الشعب الذي ينخرط في مشاكله الخاصة من مأكل ومشرب ومسكن، لا يعير اهتمامًا بالحكم والسلطة، وهذه آلية سياسية تعزز من وجود النظام السياسي لأطول فترة ممكنة.
وإذا عمد الباحث إلى التشريح النصوصي للمشهدين السابقين، يجد نفسه أمام نسق مضمر/ نصوصيّ، يبدو من خلال تكرار الألفاظ الآتية: (خائف، الذعر، شاخوا، صفراء، كالحة الفقر، العجاف، صمت، حرجة..)، هذا التكرار ينطوي على نسق ثقافي مضمر، هو أن القمع نمط سائد يعيشه أهل مصر مع ثقافة التسلط المستمرة.
النسق السلطوي (¥)/ إيزيس:
يظهر هذا النسق بشكل جلي في شخصية (إيزيس)، حيث جاء كفعل ثقافي رئيس مقارنة بالأنساق الثقافية الأخرى، إذ إن وجوده يحتم وجود نقيضه، كالنسق الواعي المثقف، والمتمثل -من وجهة نظر الباحث- في صورة (ست)، الذي يحاول ترسيخ فكرة الانتماء للوطن في نفوس شعب طيبة، ومن ثم/ فإن (ست) نسق مضاد وفعل متصارع مع نسق السلطة المهيمن/ ايزيس، وهي التي تتميز بـ “القدرة على التأثير في الأشخاص ومجريات الأحداث باللجوء إلى مجموعة من الوسائل تتراوح بين الإقناع والتأثير” ([3])، ويمكن أن يستشف ذلك عبر مناجاة ايزيس ذاتها، من خلال مفارقة ثقافية، تكشف عن أساليب النظام السلطوي في الحكم والسياسية.
ايزيس: إنه لم يفهم شيئًا بعد.. نعم أوزوريس لم يتعلم شيئًا.. كنت أظن سفره وترحاله سوف يكسبه تجربة وحكمة.. ولكنه عاد بريئًا كيوم رحيله عنا.. إنه لا يريد أن يفقد براءته… والحكم لا يعرف البراءة. لعبة الحكم لا تعرف الطهر أو النبل … (صمت) يقول أحد حكماء طيبة أن السلطة تفسد الناس. أعتقد أنه مصيب إلى حد كبير، فلكي يبقى الإنسان في السلطة لابد أن يكون قويًا،
أن يخادع ويناور يضرب هذا بذاك، ثم يعود ليضرب من سبق أن نصره وينصر من سبق خذله. (صمت) وكاهن رع (تنفجر ضاحكة) إله الشمس رع.. أليس بدعة من بدع أوزوريس وأسلافه من قبله؟ ألم يخلقوا رع ليعبر عن حاجة ويسد فراغًا؟ الناس، وأولهم زوجي وأخي يفصلون آلهتهم على قدر حاجتهم. لمَ ينكر علي إذن أنني استخدمت سلطة المعبد لأحكم الناس؟ (صمت) الناس.. الناس في طيبة … (بلهجة ذات مغزى).. طيبون.. لا دخل لهم في السياسة وشؤون الحكم. وإذا أعطيتهم شبعوا.. وإذا شبعوا فربما.. ربما.. يفكرون في شؤون دولتهم… ساعتها لن تبقى لنا سلطة في طيبة. أما إذا شغلتهم.. أنتم تعرفون البقية.. لكن هذا ما لا يعرفه أوزوريس…. وتلك هي براءته. ([4])
إن الرؤية الفوقية السلطوية التي بدت على ايزيس، تكشف عن حقيقة سياسية راسخة على مر العصور، حيث إن الحكم لا يعرف البراءة، والسلطة تحتاج إلى حاكم قوي مخادع ومناور، كما أنها أشارت إلى دور المؤسسات الدينية في مناصرة الحاكم حتى ولو كان ظالمًا، ورمزت بذلك إلى إله الشمس رع، فهو بدعة من بدع أوزوريس وأسلافه من قبله؛
وقد طرحت سياسة التعامل مع الشعب، وهي سياسة سلبية، تحاول قدر المستطاع تغيب الشعب ثقافيًّا عن شؤون دولتهم، ومن هنا تكشف هذه الرؤية عن نسقين متصارعين ومتناقضين، يشكلان الواقع الوجودي السياسي بكل صوره، السلطة التي تفرز معاني الهيمنة والقوة والمركز، والشعب الذي تسيطر عليه مشاعر الضعف والانكسار والهامش.
كما عكست جدلية الحوار الذاتي السابق بما فيه من ملامح الاستهزاء والاستخفاف بالشعوب البسيطة عن ضرورة ممارسة أساليب العنف والقهر، لاستمرار الأنظمة السياسية بإستراتيجيتها القمعية في الحكم، وهذه حقيقة وجودية لا مناص فيها. ومن ثمَّ/ فإن الكاتب عندما استدعى الشخصية الأسطورية، استطاع أن يلعب على أوتارها بحرفية تامة، حيث أضفى عليها ثقافته ورؤيته في الحكم والسياسية، ربما ذلك أعطى للمنتج التراثي شكلًا جديدًا يحيل إلى طبيعة الواقع آنذاك بأنظمته السياسية السلطوية،
ويظهر ذلك بوضوح عندما قامت ايزيس بثورة على (ست) المغتصب من وجهة نظرها للحكم بعد قتل أخيه أوزوريس، فقد ألقت خطبة في الشعب؛ لتستميل قلوبهم، وتسيطر على عقولهم بوهم الأسطورة (عودة روح أوزوريس مرة أخرى)؛ لتستقطبهم إليها، فتقول:
إيزيس: يا أبناء طيبة.. اذهبوا.. انتشروا في الأرض … بشروا أهل طيبة بالخلاص.. بشروا الناس أن ساعة الخلاص قد اقتربت.. بشروهم بأنه لن يبقى في طيبة بعد اليوم جائع أو عريان.. لن يبقى فيها مظلوم أو مهضوم، فقد عادت روح أوزوريس.. ولن تمضي شهور حتى يعود ابنه حورس.. نعم، حورس، وهذا سر تعرفونه لأول مرة.. سوف يعود حورس الذي خبأته في الشمال بعيدًا عن يد البطش والقدر.. سوف يعود على رأس جيش جرار ليحرر طيبة من عذابها (صياح وهتاف) اذهبوا.. انتشروا في الارض….([5])
يتوارى النسق السلطوي ويبث الكاتب من خلاله أفكاره الذاتية خلف موروثات ومعتقدات شعب طيبة، فهم يحبون أوزوريس، لأنه رمز الخير والمحبة والسلام، ومن جانب آخر فشلوا في التأقلم مع سياسة (ست)، التي ترفض سيطرة السلطان الإله، وتعزز من فكرة السلطان البشر، فقد تعرضوا للجوع والفقر، ومن ثم: تستغل إيزيس تلك القناعات، وتقوم بثورة ضد (ست) وتنجح في خداع الناس وكسب ودهم بالشرعية (التي جمعت أشلاء زوجها المبعثرة لتعيده للحياة)، وأيضًا من خلال اختلاق أسطورة حورس المزيفة.
إن النسق السلطوي انطوى على معرفته التامة بثقافة الهامش، لذلك أصبح علامة ثقافية دالة على فلسفة الحكم والسلطة، وعلى ذلك تكون الدلالة النسقية المضمرة مجسدة للواقع الفكري والثقافي معًا، وهذا وإن دل فإنما يدل على الإيمان الكامل بالحاكم الفرد فعلًا وقولًا، فتصبح التبعية من قبل الجموع سمة سائدة في ظل الهيمنة وقوى المركز.
نسق الحرية/ ست:
إن المتتبع لشخصية ست منذ بداية المسرحية حتى نهايتها، يستطيع أن يتعرف على الدلالة النسقية المضمرة لتلك الشخصية خلف قناع اللغة، فهو دائمًا يحاول إثبات وجهة نظره في الحكم، وهي وجهة تختلف جذريًا عن وجهة أخيه أوزوريس، فأوزوريس هو الحاكم الذي يفعل كل شيء،
بينما ست هو الحاكم الذي يشارك الجموع في القرارات وإستراتيجيات الدولة نحو التقدم (الإنسان لا يكون.. بل يصبح)، وهذه كانت من أهداف ثورة 1952م، التي ترغب في الإصلاح، وعبر حوار جدلي بين الأخوين، تتجلى صراع الثقافات حول السلطة والحكم.
ست: خطاك الأكبر أيها الملك أنك لا تعرف ماذا فعلت بشعب طيبة. (صمت) لقد انهار كل شيء لأنك صنعت كل شيء.. أنت أوزوريس ملك طيبة، وابن رع، هو الذي أقام السدود وشق القنوات ومهد الطرق. ليس الأمر مجرد ملكة أساءت استخدام السلطة،
ولكنك حينما رحلت خلفت وراءك في طيبة شعبًا عودته أن يعتمد على الحاكم، علمته أن الحاكم هو الذي يأتي بالمعجزات لهذا كان من السهل على إيزيس أو الكاهن الأكبر أن يفعلا ما شاءا، لأن أهل طيبة كانوا شعبًا بلا إرادة.. وحينما يفقد الشعب إرادته يستطيع الحاكم أن يفعل به ما يشاء([6])
إن الجدل الأنساقي السابق يكشف عن حقائق ملموسة واقعًا وتخيلًا، وفي الوقت نفسه يحمل صراع الثنائيات الثقافية، التي تجلت في الفعل والفعل المضاد؛ حيث إن أوزوريس وقع تحت سلطة نسقية معينة، وهي نمطية السلطة المركزية في الحكم أو بالأحرى الوفاء الثقافي التام للسلطة- إن جاز التعبير، وهذا ما أدى إلى ظهور طبقة ثقافية دُنيا أساءت استغلال السلطة، وما بين هذا وذاك يفقد شعب طيبة الإرادة، وتصبح الفلسفة الثقافية في الحكم، هي المحك الرئيس في توليد الجدل.
أوزوريس: (في موقف الدفاع تمامًا) لكنني لم أكن أبدًا طاغية يا ست.. كنت دائمًا أقرب إليهم مما يتصورون: وإذا كانت إيزيس قد قهرتهم فلماذا لا يأتون إلى الآن؟
ست: لم أكن أتوقع منك أن تفهم.. قلت لك أن الأمر ليس قهر إيزيس لهم طوال عشر سنوات.. لكن المشكلة أن أحدًا لم يرفع صوته محتجًا طوال غيبتك.. لم يقل رجل واحد في طيبة لا..
أوزوريس: (واقفًا في هدوء) وهذا ما تريد أنت أن تفعله الآن..
ست: (في هدوء) نعم سوف أحاول أن أعلمهم أن الإنسان لا يكون يا اوزوريس، بل يصبح ما يريد هو… ([7])
يحاول ست تسيد مبدأ الديموقراطية في حكم الشعب، أي أن تكون العلاقة بين الحاكم والمحكوم عليه قائمة على الأخذ والعطاء، فلا ينفرد طرف على الآخر، لتصبح المعادلة السياسية صحيحة، ويمكن تحقيقها بشكل أمثل واقعًا، فالدور السلبي الذي تولد من الاتكاء على الغير/ الحاكم، أثّر بشكل ملحوظ في هدم الأفراد فكريًّا وثقافيًّا وحضاريًّا، وهذا ما يتْبعه هدم المجتمع بأكمله، لذلك جاءت ثورة 1952م هادفة إلى بناء فرد واع له رأي، ودور مؤثر في المجتمع على المستويات كافة.
كأن ست في الحوار الثقافي السابق يحاول أن يعبّر عن سلبيات النظام الديكتاتوري، الذي شيده أوزوريس عن غير قصد، فالشعب لم يتعود على الرفض، فهو مفتقد الإرادة في التعبير عن آرائه بالقبول أو الرفض، لذلك يحكم ست شعب طيبة، ويحاول تطبيق أفكاره المعرفية، لكنه يفشل في ذلك، وتصبح السلطة والهيمنة هي مصير شعب طيبة.
النسق القناع/ الكاهن الأعظم:
يعد القناع أداة ثقافية مهمة داخل بنية الخطاب النسقي، والقناع الذي أقصده هو القناع الديني الذي يتخفى تحته رجل الدين من أجل تحقيق رغباته الشخصية، وهي حالة ثقافية لها جذور عميقة على مدار العصور التاريخية، فقد عملت على استغلال انصياع الشعب لكلمة الدين، ليصبح على إثر ذلك أداة السلطة والحكم في تمرير سياستها من أجل الحفاظ على وجودها، وبذلك تكسب السلطة ود الشعب بطريقة شرعية، ورجل الدين هنا هو الكاهن الأعظم (كاهن معبد رع)، الذي يساند ويشارك النظام السياسي رغم معرفته التام بظلمه وفساده، ليصبح صوت السلطة الداخلي.
ايزيس: في صوت خفيض هل عاد حقا؟
الكاهن الأعظم: نعم يا مولاتي
ايزيس: وخطتنا؟
الكاهن الأعظم: لابد أنها فشلت
ايزيس: وانت الذي وعدتني..
الكاهن الأعظم: (في غيظ) هذا الغبي.. لقد نبهت عليه.
إيزيس: دعك من هذا الآن.. (ثم مشيرة إلى الناس في الساحة فيما يشبه الاحتقار) لابد أن نقول لهم شيئًا ([8])
إن الكاتب يدرك قوة كلمة رجل الدين قديمًا وحديثًا، وعلى ذلك يعري الأنظمة الدينية واقعيًّا، فالكهنة ما هم إلا انعكاس حقيقي للمؤسسات الدينية.
ست: مولاي كاهن رع؟
الكاهن الأعظم: (وقد أجفل قليلًا) أنت هنا؟
ست: (بسخرية واضحة) طبعًا وهل أُضيع فرصة كهذه؟
الكاهن الأعظم: لم أكن أظن أنك (يتوقف)
ست: تجرؤ؟
الكاهن الأعظم: لم أقل هذا.. ولكن لا بأس.. نعم.
ست: جئت لأشهد العرض..
رئيس الكهنة: (بدهشة) العرض؟ ما هو العرض؟
ست: كيف تحرك الجماهير، وتلعب بمشاعرهم؟
الكاهن الأعظم: (مؤكدًا كل كلمة نحن لا نؤثر.. بل نوجه..)
ست: (مرددًا بنفس التأكيد): نحن… لا نؤثر.. بل.. نوجه..
رائع طالب التعبير البليد
الكاهن: من تقصد؟
ست: أنت تعرف جيدًا من أقصد.. ألم نكن شركاء فصل واحد؟
الكاهن: (بسرعة) نعم.. نعم …
ست: والآن تعلمت أن تقول نحن..
الكاهن الأعظم: (مؤكد) نحن لا نصبح بل نكون ..
ست: (ينفجر ضاحكًا) رائع.. رائع… ([9])
هذا التعبير النسقي الثقافي (نحن لا نصبح بل نكون)، يحيل إلى قوة سلطة رجل الدين، فهو دائمًا صوت الحق، يوجه ويعالج وينصح، وهو سبيل الخلاص للإنسان؛ لذلك تستخدم السلطة رجل الدين لأغراض سياسية.
الكاهن الأعظم: يا اهل طيبة… يا اهل طيبة..
باسم رع.. رع اله الشمس الاعظم… حامي حمى طيبة.. ومجرى النهر العظيم…. وبحق الخدمات التي قدمها ابن رع للبشرية… نعلن نحن.. كاهن المعبد… ان اوزوريس قد أصبح منذ اليوم إلها من آلهة السماء.. يقدس ويعبد كبقية الآلهة ([10])
يلحظ هنا أن الثقافة النسقية/ رجل الدين تكشف عن قوتها مقارنة بقوة السلطة، حيث إنها قادرة على جعل الحاكم إلهًا للطبقة المهمة.
نفتيس: .. إيزيس هي التي حولت عمائر طيبة إلى خرائب.
ست: تقصدين الكاهن الأعظم؟
نفتيس: (في ذعر) الكاهن الأعظم يمثل رب الأرباب رع
وإرادته من إرادة الآلهة..
ست: لهذا تمتلئ خزائن المعبد بالذهب وخزانة طيبه خاوية… ولهذا تمتلئ مخازن رع بالحبوب والغلال والناس يتساقطون من الجوع.. لهذا تدخل القرابين التي جاءت بها الوفود أمس، والتي كان من الممكن أن تخفف من ضائقة الشعب إلى المعبد لتقدم على مذبح الكاهن الأعظم.. ([11])
إن الكاتب هنا يؤكد على صورة رجل الدين النقية في نفوس الشعب، حيث إن زعزعة هذا الركن أمر في غاية الصعوبة، فهم السبيل إلى الخلاص.
نسق السخرية/ النكتات:
يتجلى هذا النسق في الطبقة المهمشة التي تسخر من الواقع السياسي بصورة كوميدية، وهي ثقافة أصيلة متجذرة بعمق في بنية المجتمع، يلقي الكاتب الضوء عليها، حيث إنها تعد حالة انعكاسية للتنفيس الإنساني بصوره كافة.
عضو (3): هل سمعت نكتة أهل طيبة الأخيرة؟
عضو (4): أية نكتة؟
عضو (۳): (يرتفع صوته، ويستمع الجميع بما فيهم ست) فيه اثنين فشارين في طيبة.. الأول قال للثاني أبويا اشترى لنا حلة قد طيبة كلها.. الثاني قاله: وإيه يعني.. أبويا زرع کوسة وطرحت واحدة تسد مجرى النيل.. الأول قال له: طيب، وتطبخوها في إيه؟.. الثاني رد عليه: ودى حاجة عايزه كلام دي، في حلة أبوك طبعًا. (ضحكات من الجميع بما في ذلك مهندسا الري والاستصلاح.. ابتسامة ساخرة من ست… ثم ينقر بأصابعه على المنضدة).
ست: لو أن أهل طيبة قالوا في العلن ما تقوله نكاتهم في السر لما بقي واحد منا هنا في مكانه([12])
يعد الضحك سمة بارزة في ثقافة أهل طيبة، فهم يعرفون كل شيء، ويدعون الأمور تسير على هوى الحاكم، ويستمرون في إطلاق النكات، وعلى ذلك فإن النسق الهامشي يهرب من الواقع بالنكات.
¥) مسرحية الناس في طيبة، هي مسرحية مكونة من أضلع ثلاث -إن جاز التعبير، كل ضلع يمثل ثقافة بعينه، حيث إنه توارى خلف عدة أنساق تراثية أو بالأحرى خلف الرمز الأسطوري (إيزيس/ أوزوريس)، وأعاد صياغة مفردات الأسطورة من جديد، وشكّلها ثقافيًا لتناسب واقعه ورؤيته السياسية في الحكم والسلطة، فشخصية (ست) ليست الشخصية الشريرة التي وردت في الأسطورة، بل هي الشخصية الثورية التي تسعى إلى تحقيق أهداف نبيلة كالحرية والديموقراطية …،
لاسيما التحرر من التبعية والانغلاق على الذات إلى الانفتاح على النهضة والتنمية، ومن جانب آخر أصبحت إيزيس صورة السلطة الماكرة التي تستخدم كافة الحيل من أجل الوصول إلى الحكم والسلطة، فهي أنموذج للحاكم الذي يتلاعب بالشعب فكريًا من أجل تحقيق رغباته الشخصية، ويعد أوزوريس لشعب طيبة القوة المحركة للحكم فكريًا ونهضويًا، وهذا ما أدى إلى اعتماد الشعب عليه بشكل كلي، حتى ظهر في صورة الشعب الاتكالي، وهي صورة سلبية حاول (ست) تغييرها، فقد كان شغله الشاعل تحرير الإنسان من كل قيود التبعية، حتى يصبح التغيير نابعًا من الإنسان ذاته لا من الآخر، ومن ثمَّ/ فإن المسرحية سلسلة درامية مكونة من مجموعة ثقافات متصلة تارة ومنفصلة تارة أخرى، تكشف عن صورة واقعية للحكم العربي، الذي يظهر مرة في الحكم الفردي، ومرة أخرى في الحكم الجماعي الذي ينادي به الكاتب.
¥) إن الحديث عن عبد العزيز حمودة يأتي من خلال شقين، عبدالعزيز حمودة ناقدًا، وعبدالعزيز حمودة مبدعًا، فالجانب النقدي عند الكاتب يتجلى في مشروعه النقدي، الذي يهدف إلى المحافظة على الثقافة العربية وهويتها، في ظل الانفتاح الملحوظ على الغرب، فهو يحاول الحفاظ على العقل العربي من الاستلاب الثقافي الغربي، والجانب الإبداعي يظهر في مسرحياته الخمسة التي تطرح أيديولوجية الكاتب في الحكم والسلطة، وعلاقة الحاكم بالشعب، ودور الشعب في النهضة والتنمية، وكان التراث بمصادره المختلفة معينًا خصبًا للكاتب في التواري والتقنع؛ لتظهر ثقافة الواقع الجدلية في صورة درامية حية، وقد اختار الباحث من مسرحياته، مسرحية (الناس في طيبة)؛ لتكون أنموذجًا دالًا على فلسفة الكاتب الثقافية في الحكم والسلطة.
([1]) الأعمال الكاملة لعبد العزيز حمودة (1)، مسرحية الناس في طيبة، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1989م، ص 17.
¥) إن السلطة كنظام فوقي لها جذور عميقة عبر العصور، حيث إنها ارتبطت بالإنسان، فوجودها لازم الإنسان منذ تكوينه، وقد شهدت تطورًا ملحوظًا نتج من تطور الإنسان والمجتمع، فأصبحت ذات خصوصية معينة، حيث ارتبطت بسياقات المجتمع كالسياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي، فهي عند فوكو ” أيديولوجية يلازمها نسق القوة، والعنف هو المكون الأساسي لها تجاه علاقتها مع المجتمع الآخر”. ينظر: بادئ هندسي، خطاب السلطة من هوبز إلى فوكو، ترجمة/ مرفت ياقوت، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، ط1، 1996م، ص126.
([3]) ميشيل فوكو، المعرفة والسلطة، تر: عبد العزيز العيادي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط1، 1994م، ص43.
([6]) الأعمال الكاملة لعبدالعزيز حمودة (1)، مسرحية الناس في طيبة، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص39.




