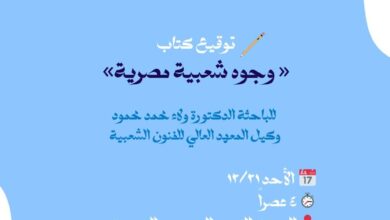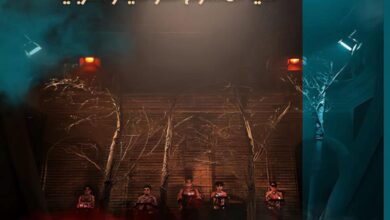صدر مؤخرا عن دار العلم والايمان بالقاهرة كتاب ( المنطق المونتاجي في النص المسرحي – ودراسات أخرى) للأكاديمي العراقي دكتور منصور نعمان..
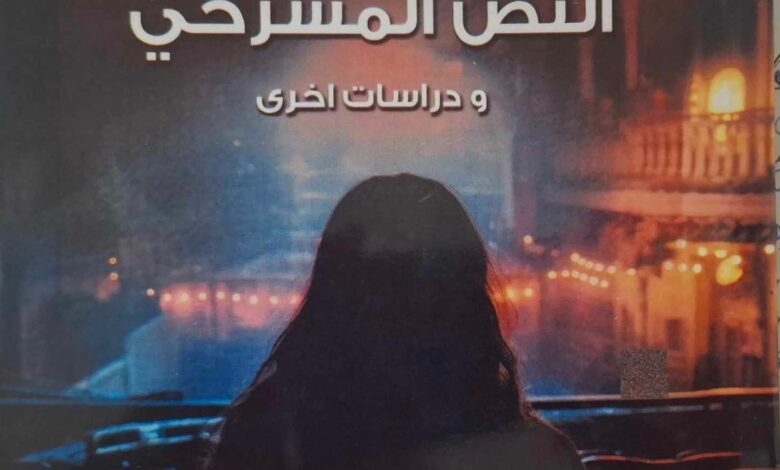
المسرح نيوز ـ القاهرة| إصدارات
ـ
كتبت| نور مطاوع
صدر مؤخرا عن دار العلم والايمان بالقاهرة كتاب ( المنطق المونتاجي في النص المسرحي – ودراسات أخرى) في 230 صفحة للأكاديمي العراقي دكتور منصور نعمان..
قسم المؤلف الكتاب إلى أربعة فصول وكل فصل يحتوي على موضوع مختلف عن الآخر، ولكل فصل جانبين: الأول نظري والآخر تطبيقي وعلى النحو التالي:
الفصل الأول: المنطق المونتاجي في النص المسرحي – ودراسات أخرى
وتطرق الى المونتاج في النصوص المسرحية: الإغريقية والشكسبيرية وكذلك في نصوص تشخوف المسرحية، وتم تتبع الصيغ المونتاجية
فظهر في المسرحية الاغريقية: التوازي بين الجوقة والبطل / التداخل بين والابطال/ التقاطع بين الابطال أنفسهم/ السرد الذي تقوم به الجوقة وما ينهض الابطال به من أفعال
اما شكسبير فقد سعى الى استخدام المونتاج من خلال عملية الحذف الزائد للأحداث والتركيز على الحدث الأساس، فأحيانا يستخدم المونتاج القافز/ المونتاج المتوازي بتركيب حدثين متوازنين
أما تشخوف فقد اعتمد على المونتاج بانواعه: السلس/ والمتوازي والقافز.
وهذه المرونة المونتاجية جاءت لخدمة الشخصية والحدث ذاتهما
وقد اخذت مسرحية ا(لام شجاعة وأولادها) لمؤلفها( برتولد برشت)
وتم تفكيك النص من خلال المحاور المونتاجية التالية : المونتاج المتوازي/ تركيب الحدث
الحوار- الصدمة/ إرشادات المؤلف في نصه فالأصوات تتوازى أو تتداخل أو تتقاطع
وعلى وفق ما تقدم ، فان النتائج جاءت متعددة ومن أهمها:
1- تركيب الحدث ذاته اعتمد على البناء المونتاجي
2-تم إيقاف نمو الحدث لتمارس عملية القطع
3التنافر والتضاد بالحوار
4- اتساع رقعة الراوي ساردا للملمة الاحداث
5- التوازي المونتاجيفي التضاد والنفور بين الابطال
في المنظومة اللفظية-الحوار- وارشادات المؤلف التي يتضمنها النص ذاته
وتم اتباع صيغة المونتاج: السلس
اما الفصل الثاني: جذور التعبيرية في النصوص الشكسبيرية
وقد تناول الجانب النظري: التمهيد الذي تطرق الى اهم خصائص التعبيرية. وعرج الى عصر النهضة والتحولات الكبرى التي شهدها، والمحور الرومانسي وأثره في الحياة آنذاك، كما تناول خاصية البطل الشكسبيري واتساع ذاته وتشربه للأفق الميتافيزيقي بالمقارنة مع الواقع المتغير، اذ لم يعد يثق بالماضي، ويشعر بمجهولية المستقبل
بينما تناول الجانب التطبيقي 6 نصوص مسرحية هي: مكبث. هاملت. الملك لير. منظور البطل. الامبراطور جونز. الغوريلا. الآلة الحاسبة
وتم تحليل النصوص ضمن المحاور التالية: الزمن.. منظور البطل. القناع. الاشباح. المؤثرات الصوتية في النصوص. تقنية الكتابة. الشخصية. الحوار الداخلي
الفصل الثالث: اللامعقول في نصوص تشخوف المسرحية
: واهتم الجانب النظري بالكشف عن
مستويات تأثير نصوص تشيخوف الدرامية على مؤلفي نصوص اللامعقول وعليه تم دراسة الواقعية .وتقنية الكتابة عند تيشخوف
من خلال :حبكة اللاحبكة. البطل اللابطل. الماضي والحاضر.
اما الجانب التطبيقي فقد تناول نصوص تشيخوف وهي:
اليوبيل، طلب يدها للزواج، مضار التبغ، أنشودة البجعة، الدب، النورس، الخال فانيا، بستان الكرز.
اما نصوص اللامعقول فهي:
قصة حديقة الحيوان لمؤلفها ادوارد ألبي، الكراسي واميديه لمؤلفهما يوجين يونسكو، الأستاذ تاران لمؤلفها آرثر أدموف، الجلادان لمؤلفها فرناندو أربال، رماد من رماد لمؤلفها لمؤلفها هارولد بنتر. وظهر بعد التحليل، النتائج التالية وهي:
ظهر تأثر كتاب اللامعقول بتقنية تشيخوف الدرامية
شكل نصوص اللامعقول المتهشم، كانت امتدادا لنصوص تشيخوف
الفصل الرابع: الرموز الثقافية في النص المسرحي
وتم الإشارة الى طابع الثقافة واقترانها بالعصر الذي تمثله فتشكل إطارا فلسفيا وبنية ذهنية للمجتمع ذاته وتناولت الدراسة:
الرموز الثقافية في الحياة الاجتماعية
الرمز ودلالاته في النص المسرحي الاجنبي
وفي تحليل نص مسرحية (ميت مات) لمؤلفها عبدالنبي الزيدي والبطلين هو1 و هو2 ضمن المحاور التالية:
عتبة: النص التي شكل توالدية في التساؤل. مما يزيد بالقلق الوجودي
الرمز: وظهر انه لا يأخذ شكلا ايقونيا وانما مفهوما متحركا بأكثر من اتجاه
وكان الايمان بالرمز مفرطا بلغ حد التماهي بوصفه مخلصا لا للبطلين حسب بل للبشرية
الانتظار: جعل من الانتظار امتدادا لزنزانة الخوف. وما انتظار المنتظر الا سوء تقدير من البطلين ،فالمنتظر الغائب لم يكن غائبا وان كان منتظر عبر حقب التاريخ
التابع والمتبوع: كان كِلا البطلين ينتظر أحدهما الآخر، وهما لا يعرفان عن ذلك المكان