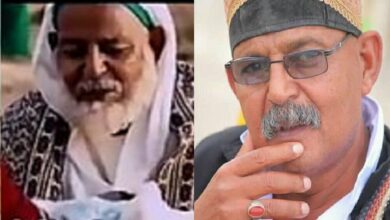الفنان الكبير “عبدالعزيز مخيون” يكتب: النجومية تقتل الموهبة!

المسرح نيوز ـ القاهرة | متابعات
ـ
منذ أن جاءت تلك السيارة إلى قريتنا في عزبة مخيون، القريبة من أبوحمص، وأنا أشعر بأنني سأكون مثل الرجل الذي راح يردد في الناس من حوله: بس منك له.. له.. له.. لها.. إنه السيد بدير في فيلم قامت ببطولته شادية مع عماد حمدي في إحدى القرى. ولكن كل ما بقي لدى الناس من هذا الشريط السينمائي الذي عرض في ساحة العزبة هو تلك الكلمات.
عرفت في تلك الآونة أن ما يردده الممثلون على تلك الشاشة يمكن أن يكون مؤثرا لدى الناس، خاصة إذا ارتبط بمكانة هذا الممثل عند الجمهور. فقد كانت تأتي سيارة يمتلكها أحد أعمامي، بآلة عرض وشريط سينمائي من وقت لآخر، وتعرض علينا فيلما جديدا يبعث البهجة في القلوب.
ولذا كنت أشعر دوما بالسعادة وأنا أصطحب أبي إلى دار العرض التي تقيمها البلدية في مدينة دمنهور، وإذا ذهب أحد من أقاربنا إلى الإسكندرية، فيكون كل همي أن أصحبه لرؤية فيلم جديد، فعرفتني دور العرض الكبيرة في الثغر مثل أمير، وريو، ومترو.
ولكن، برغم عشقي الجنوني للسينما، فان بدايتي كممثل كانت من خلال المسرح. ويبدو أن قيامي بتقليد الكبار، في القرية، قد نبه إلي الأنظار، وكان ذلك سبباً في أن أقوم بالتمثيل في حقل نهاية العام الدراسي. وأنا في سن العاشرة في مدرسة القرية. وكان ذلك بداية لرحلة معاناة طويلة لم تنته حتى الآن. وفي هذه المسرحية، حدث شبه تطابق بين موضوعها، وبين أفراد أسرتي، فقد كنت أمثل دور فلاح يعمل خادما لدى أحد الباشاوات، فينكل به، ويوبخه، ويعنفه، إنها نفس حكاية عمي الذي طبق عليه قانون الإصلاح الزراعي مرتين. لذا كنت واعيا بحكاية أسرتي وأنا اقرأ النص.
لكن، ما لبثت علاقتي بالتمثيل أن انقطعت بعد أن التحقت بالمدرسة الإعدادية. فشغفت بالموسيقى ورحت اعزف على آلة الكمان، وفي الصف الرابع الإعدادي عدت ثانية إلى التمثيل، ورحت أصقل موهبتي بالقراءة، ومتابعة أخبار الفنون في المجلات السيارة، وشغفت بكتابات المنفلوطي، كما وجدت نفسي أكتب قصة قصيرة شعرية، ولكنني لم أتوقف أبدا عن العزف على الكمان.
البداية: مسرح المدرسة
وفي الصف الثالث الثانوي، ولأنني كنت أحب اللغة الإنجليزية، اشتركت مع مسرح المدرسة في تمثيل مسرحية “مخلب القرد” للكاتب و. و. جاكوب، من إخراج محمد غنيم. كانت تجربة مثيرة، استطاعت أن تغير مجرى حياتي، فبدلا من أن أفكر مثل زملائي في الالتحاق بكلية الهندسة أو الطب، قررت أن أدرس التمثيل.
وقد وجدت نفسي أمام خيارين بالغي الصعوبة، إما أن أدرس الموسيقى، أو أن التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ولم يكن أمامي سوى المسرح بعد فشلي في الالتحاق بالكونسرفتوار. وكان الغريب أنني التحقت بمعهدي السينما والمسرح في نفس الوقت، وقررت أن أتفرغ للتمثيل.
ومنذ اللحظة الأولى، بدأت معاناتي في مدينة واسعة كالقاهرة، حيث حال عدم وجود وساطة دون دخولي المعهد، برغم نجاحي في القدرات. فكتبت شكوى إلى الوزير عبدالقادر حاتم، الذي قبل التماسي.. وأصبحت طالبا.
كان على جيلنا أن يعمل معا، لذا اشتركت في تمثيل أفلام زملائي المخرجين في معهد السينما، فعملت مع هاشم النحاس، وعبداللطيف فهمي، وآخرين. وكان ذلك بداية للعمل في التليفزيون والمسرح بعد تخرجي. ثم جاءتني منحة من الحكومة الفرنسية لدراسة اللغة والحضارة الفرنسية في باريس، ولكنني عندما وصلت إلى هناك رحت أدرس طرق ومناهج العمل في المسرح.
وما إن عدت إلى القاهرة، حتى بدأت نشاطا مكثفا، فعملت في دور قصير أمام فريد شوقي في فيلم “أيام العمر معدودة” إخراج تيسير عبود، ثم جاء دوري في فيلم “إسكندرية ليه” ليوسف شاهين، الذي فتح لي أفق التعامل من جديد معه في فيلمه التالي “حدوتة مصرية”. وكان ذلك بمثابة أول الطريق نحو بطولات سينمائية عديدة خاصة في السنوات الأخيرة، فبعد “الجوع ” لعلي بدرخان.. هناك “الهروب” لعاطف الطيب. و”شحاذون ونبلاء” لأسماء البكري، و”فارس المدينة” لمحمد خان.
وخلاصة ما يمكن أن يقال عن السينما المصرية الآن أنها سينما راسخة، بدأت على أسس صحيحة، ولذا فعندما ينظر إليها واحد من أبنائها، فإنه يراها قد احتفظت بهويتها، برغم الظروف الصعبة التي تمر بها من وقت لآخر. ويتمثل ذلك الرسوخ في كفاءة العاملين بها، وخذ على ذلك مثالا مديري التصوير وعمال الكهرباء، والإضاءة، وبعض أعمال الديكور.
إذن، فالسينما المصرية لها نظامها، وقد سبب لي هذا النظام الراسخ الكثير من الراحة، ودفعني للتكيف معها، كما أنني عند العمل في السينما أعرف كيف أكثف مشاعري. وذلك من خلال معرفتي متى تبدأ اللقطة، ومتى تنتهي. وهي أمور قد لا تتوافر كثيراً في التليفزيون، وبالطبع في المسرح. وعن العمل في فيلم ما، فأمام الممثل فرصة أكبر لدراسة الشخصية، والغوص في أعماقها. فعندما قمت بدوري في فيلم “الحكم آخر الجلسة” لمحمد عبدالعزيز ذهبت إلى طبيب متخصص في الأمراض العقلية، وأعطاني ملفا طبيا عن أمراض التخلف العقلي.
وقبل أن أدخل إلى البلاتوه لتمثيل دوري في فيلم “الهروب” رحت أسجل شرائط الحوار كله صوتيا مع الصعايدة. فأنطق الجملة على الشخص الصعيدي الذي أمامي، وأجعله يرددها. مما يتيح لي نطقها كما يجب. بالإضافة إلى قيامي باختيار ملابسي من نفس الملابس التي يرتدونها.
قتل الموهبة
إذن، السينما تعطيني قربا من الطبيعة أكثر، فعندما نصور مشهدا في أحد الحقول، فإن الديكور من حولنا يكون طبيعيا: المصارف، والمزارع، والفلاحين، كله من الطبيعة. أي أن المكان نفسه يعطي الممثل المصداقية عند التصوير الخارجي. ولكن هل السينما كلها خير.. أو أن بها بعض الشر؟ بمعنى هل استخدم العرب السينما من أجل التطوير، أو لاستحداث أنماط اجتماعية، وسلوكية جديدة أغلبها يدخل في إطار السلبية؟ وإذا أردنا إجابة مؤكدة، فلنقرأ معا هذه الفقرة من كتاب “المصريون” لقاسم أمين الذي نشره مع بداية نشأة السينما: “.. أن مصر تتحول إلى بلد أوربي بطريقة تثير الدهشة وقد غدت إدارتها وأبنيتها وشوارعها وعاداتها ولغتها وأدبها وذوقها وغذاؤها وثيابها تتسم كلها بطابع أوربي“.
في هذا المناخ جاءت السينما إلى مصر، ولو أحصينا مجموع ما أنتجته السينما في مصر من أفلام – قد يبلغ ألفين وسبعمائة فيلم – فسوف نجد أن أغلب هذه الأفلام تقليد للسينما الأمريكية، فالموضوعات مأخوذة من أفلام أمريكية، والصورة السينمائية نفسها عبارة عن تقليد ومحاكاة ساذجة للصورة السينمائية في الفيلم الأمريكي. ويذكر كتاب “الاقتباس في السينما المصرية” لمحمود قاسم أن الأمر لم يكن مقصورا على اقتباس الحكاية أو النص فقط، بل تأثر التقليد بالموجات التي طرأت على السينما الأمريكية مثل موضة الكوميديا الموسيقية في الأربعينيات والخمسينيات، ثم موضة أفلام الديسكو وأفلام الكوارث والتقمص والخيال العلمي. فكانت الرقصة مع الأغنية قاسما مشتركا في معظم الأفلام حتى لو لم يكن لهما مبرر درامي.
كما أن النظام السينمائي الموجود في الوطن العربي هو قاتل للمرهبة، فهناك كرسي وهمي اسمه “النجومية” الذي يعتليه لا يود النزول من فوقه، حتى لو أفلس، والممثل دائما ما يتم حصره في دائرة ضيقة. وبرغم أدواري التي حصلت بعضها على جوائز، فإنني ظللت مؤطرا لفترة طويلة. ومع ذلك فان إحساسي الحقيقي بالنجومية يأتي من رجل الشارع، الذي ألقاه في الطريق. وكثيرا ما أحس بأن ما يربطني بالناس ليس هو الانبهار بما أقدمه على الشاشة، بل الاحترام تجاه ما أقدمه لهم من أدوار. وثروة الفنان لا تنحصر في المبالغ التي يحصل عليها عند توقيع العقود، ولكن ما يرسخ لدى الناس من المبادئ والأفكار التي يجسدها لهم على الشاشة.
لذا، فالممثل يجب أن يكون رمز المواقف، وأن يتمتع بثقافة واسعة، فالثقافة تجسد الموهبة، وتصقلها، وتجعلها تتفتح، ولكنها في نفس الوقت تعتبر عبئا في مجتمع تنهار فيه القيم، فالفن يولد البهجة والفرحة لدى الناس. كما أنه يساعد البشر على تكشف أدوارهم في الحياة، ويدعو الإنسان إلى أن يستخدم عقله، حتى يحتمل الموجودات المحدودة التي يعيش في إطارها فالثقافة تجعل الإنسان يعرف ويكتشف في مجتمع قد يجبر الإنسان على أن يغيب عقله، أو أن يرضى بالحياة على طريقة غريزة القطيع، فيما أن يعيش وسط هذا القطيع، أو أن ينبههم إلى ما هم عليه، وأن يجعلهم يفكرون. وهذه مهمة صعبة، وتحتاج إلى طريقة معقدة للوصول إلى قلوب الناس. لكن مع الأسف، ليس لكل الفنانين ثقافات واسعة، ومواقف محددة من الحياة، وشعور ما بأن ما يقدمه يجعله موضع احترام الناس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلة العربي الكويتية/ العدد 439/ 1 ـ 6 ـ 1995م